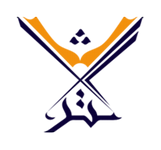أنت الآن هنا: الصفحة الرئيسة - نافذة على مزاب - التراث الإباضي - إصلاحا للفكر العقدي
نافذة على مزاب
إصلاحا للفكر العقدي
د. مصطفى ناصر وينتن- أضف تعليقا
- تعليقات : 0
- مشاهدة : 2561
حبى الله تعالى المجتمع الإسلامي عقيدة ذات مبادئ وأهداف لم تكن في عقيدة من العقائد السالفة ولم تتوفر لعقيدة متقدِّمة ولا لفلسفة في الوجود قبل ولا بعد، وكان منطلقها وديوانها الذي حواها القرآن الكريم؛ وقد وصفه الله تعالى في أثره على من اتبعه وقال "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا(9)" (س/الإسراء)، ذلك أنه ما فرط فيه من شيء، في علاقة الإنسان بربه أو بغيره من الكائنات، وجاء القرآن من خلال العقيدة التي بشر بها وبآثارها ليربي الناس ويدعوهم لما يحييهم. تلقى المسلمون هذا الوحي وهذه الهداية، وبنوا حضارتهم وحياتهم الفردية والجماعية على خطوات هديه وإرشاده، فكان ملازما لهم، وأصبح صلاح أمرهم وقوامه مرتبطَين أشد الارتباط بمدى احتكامهم إليه، وقربهم أو بعدهم عنه، وكذا أصبح أي تفسير للوجود الإسلامي ولأوضاع المسلمين رهينا في صدقه بقراءته على ضوء ما التزم به هذا المجتمع مع ربه في إيمانه، ومدى تحقيقه لتعاليمه في واقعه.
وأي إصلاح للوضع الذي يعيشه المسلم وحيدا أو مع غيره ينبغي أن يكون على خطوات القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية كما قيل «لا يصلح آخر هذه الأمة إلاَّ بما صلح به أولها»، وتظلُّ كل الجهود خارج هذا الإطار والمنهج مجرد محاولات لا يحالفها النجاح ـ في أغلب الأحيان ـ لأنها تجاهلت أهم مكون لهذا المجتمع بل أهملت حجر الأساس في بنائه، فتاهت في مجاهل البحث الذي لا يفضي إلى ما يشفي الغليل إلاَّ تكهنات وتخمينات، نظريات يدحض بعضها بعضا على توالي الأيام والأزمان.
والسر في قوة هذه العقيدة أنها تحمي الإنسان من كل خطر يحدق به، ما يعلمه وما لا يعلمه أو يعلمه بعد حين من الدهر، وكانت بذلك تدعو إلى كرامة الإنسان والوصول به إلى السعادة، فحمته من نفسه وبني جنسه لمَّا دعته إلى التوحيد الخالص الحق الذي لا يسيطر فيه الإنسان على غيره ولا يستوصي عليه كما قال الله تعالى: « قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ(64)»[س/ آل عمران]؛ وكانت هذه نقطة التحول العظمى في تاريخ الإنسان فتحرر من كل قيد وتبعية سوى تبعيته لمن خلقه لأنه منه يستمد القوة والهداية.
وأصبحت هذه العقيدة نور حياة دعا إليه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وقال الله تعالى في ذلك: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15)» [س/المائدة]، وضرب المثل للذين استنكفوا عن هذا النور ولم يشاؤوا أن يستضيئوا به فبقوا مقيدين إلى أغلال السفاسف وخسروا أنفسهم، وقال الله تعالى: «وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ(175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ»[س/الأعراف]؛ وكذا حذر من مغبة السقوط في فخ الإشراك الموقع في أوحال الخضوع، واضمحلال الشخصية بين الانتماءات، وتشتـتها بين الأقطاب المتعددة، وضرب المثل بالذي يتنازعه الملاك فلا هو خالص لأحدهم ولا هو قادر على الوفاء لهم جميعا، قال تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ(29)»[س/الزمر].
كانت هذه أهم أسباب قوة المؤمن والمجتمع المؤمن، ولا يكون كذلك إلاَّ بقدر ارتباطه بربه، والحال أن المسلم المعاصر عندما يعرض نفسه على هذه المبادئ وآثارها يجد نفسه بعيدا بعدا شاسعا، ويشعر بهوة سحيقة بينه وبين ما ينبغي أن يكون عليه في حقيقة أمره، مما يستدعي البحث عن كيفية الرجوع إلى الجادة وتصحيح المسار، فقد أخطأ المسلم المعاصر ـ خاصة ـ هذه السبيل، واعتراه ما يعتري ضال السبيل وسط الفلاة فلا هو يدري الصواب في الرجوع خلفا أو المضي قدما...
وليست هذه الحال وليدة الصدفة ولكنها نتيجة ركود خيم على العقول أجيالا، وغفلة عما يحاك ضد المجتمع المسلم من خطط حتى يبقى على هذه الأوضاع ولا يشعر بالخطر المحدق، بل ينبغي أن يصبح مدافعا على البقاء كذلك ومتشبثا بذلك ما أمكن، وفعلا استجاب أهل الديار لما حيك وحاق بالأمة الدمار أو كاد، وكانت النتائج أن أبناء الإسلام ابتعدوا عن دينهم وبحثوا عن المبررات تحت أنواع من الأعذار الواهية؛ وهذا ما يستدعي طرح تساؤل عن أسباب هذه الحال وسبل الخلاص.
وإذا كانت العقيدة هي الحصن الحصين للمسلم فإنه ينبغي البحث بكل صراحة وبجد: أين نحن من العقيدة؟ ما موقعها من حياتنا الفكرية؟ والعملية؟ ومن مناهجنا التربوية؟ وأين الذين وكل بهم البحث فيها وأسندت إليهم مهمة النشر أو انتدبوا أنفسهم لها؟
إن واقعنا العقدي على مستوى الفرد والمجتمع عند بحثه يظهر نتائج وخيمة، ويبعد أن ننسبه إلى ما يرضي الله تعالى ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، يبتدأ ذلك من مقاعد الدراسة والتعلم، وينتهي إلى عالم الممارسات والسلوك؛ فمازلنا نكتفي بالقليل اليسير من التوجيه العقدي في مدارسنا، لكنه توجيه يقف عند حدود تلقين المبادئ تلقينا أشبه ما يكون بالترديد غير الواعي الذي يجعل التلميذ يدرس دينه كما يدرس أية فلسفة في الوجود، لا يعنيه أن يتمثله في سلوكه ولا يسأل ذلك ولا يحاسب عليه، فأوهمنا أبناءنا أنهم راشدون قبل أن يكونوا كذلك، ولما رشدوا لم يهتدوا إلى الحق والخلق القويم؛ لأن الرذيلة قد سبقت إلى عقولهم واستهوتها قلوبهم، وطمست عليهم طريق الفضيلة وحسبوا أنهم على شيء وأنهم أبناء خير الأمم على الأرض، ولم يكن لهم من هذا سوى النسب والادعاء؛ وكانت النتيجة ضمور الشعور الديني والعاطفة العقدية وبرودتها، بل أحيانا يشعرون أنه من التخلف الانتساب إلى هذه الأصالة وهذا الحق، لأنه لم يعد يفيد في الحياة شيئا في نظر البعض.
وفي الواقع الاجتماعي حدث استبدال البدع والخرافات بالعقيدة الصحيحة الثابتة، وليس هذا جديدا على المجتمع ولكن تغيرت أنماط هذه الخرافات، وأساليبها ولونت بألوان براقة من إغراءات العصر، فكانت دجلا لكنه عصري متجدد، يزحزح الوافد فيه القديم ويزحمه كما هي سنة الحياة، كلما دخلت صيحة قضت على سابقتها وأنستها الناس ونسختها.
ويُترجم واقعنا العقدي باختصار في ضعفنا وتخلفنا عن ركب الأمم، وقناعتنا غير المجدية ولا المحمودة بالقليل بل بلا شيء، سوى أن نمد اليد إذا الناس اكتسبوا، ونستهلك إذا أنتجوا، مخالفين بهذا أهم ما دعا إليه رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي يأمرنا أن نعمل إلى آخر لحظة من الوجود ولو عاينا علامات زواله وقيام الساعة، فاكتفينا بانتظار الساعة متى؟ وهي من الغيب المنهي عن الاشتغال به، وتناظرنا في علاماتها كم وقع منها وكم بقي؟
لقد ضعفنا عن مواجهة الواقع وركنا إلى إيثار السلامة وحب المسالمة، والخضوع للمساومات فضيعنا واجبات كان المفروض أن لا نتنازل عنها، وأهمها أن نكون شهداء على الناس بالحضور العالمي والمشاركة في عمارة الأرض التي سخرها الله للإنسان، ونتج عن هذا الضعف العقدي ضعف كل شيء والشك في كثير من المقومات.
وإذا كان هذا هو الواقع فالعهدة على من؟
مهما أوغلنا في البحث عن الأسباب فإنه لا مناص من إلقاء التبعة على أهل الاختصاص ومن حملوا عبء الدعوة إلى الله تعالى، وخولوا لأنفسهم أن يتحدثوا باسم الإسلام، ونتساءل ماذا قُدِّم للمجتمع في هذا المجال، وماذا أفاد العباد من التطور الفكري لارتقائهم في سلم خلافة الله في أرضه؟
لا يمكن أن تتجاهل الجهود التي بذلها مصلحون كبار منذ بداية القرن الماضي خاصة، ولكن ينبغي أن ندرك أن عملية الإصلاح ليست ظرفية وليست محدودة زمنا ولا مكانا، بل هي مطلقة فيهما مستمرة دائمة، ومهما طال الزمن سيكون هناك دوما انحراف ينتظر من يقومه ويرجع أصحابه إلى سواء السبيل، وسيبقى في كل جزء من أرض الله نمط من العباد يحققون وعد الشيطان على نفسه إذ «قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا(62)» [س/الإسراء]، وينبغي في المقابل أن يوجد من يتحقق على يدهم نشر تحذير الله تعالى:« يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ ...(27)» [س/ الأعراف].
وما دام الأمر كذلك فإن لكل دهر رجالا، ولكل حال لبوسها، ولا يعقل أن تبقى مناهج التبليغ وطرقها ووسائلها منذ القرون الخوالي مستعملة لتؤدي الوظيفة ذاتها وينتظر منها أن تؤتي الثمار والنتائج رغم تغير الظروف والأوضاع والاهتمامات بين الناس، ولعل هذا هو الجانب الأعظم الذي أُتي من قبله المجتمع المسلم، فأصبح يدور في إشكال عقيم من ترديد أفكار ومفاهيم ليست من أصول الدين بل من المستحدثات في بعض العصور، بقيت إلى الوقت الحاضر يتشبث بها على أنها هي الأولى بالاهتمام والتلقين للناشئة والناس وعموما، وادعاء أن من جهلها فقد جهل دينه وأمر ربه.
لذا تبدو مسؤولية أهل العلم عظيمة ولازمة لا تنفك عنهم ولا تبرأ منها الذمم بمجرد جهد أشخاص معدودين، ولا بالجمود على طرق كانت مجدية في عهود غابرة، وهو ما يستدعي التفكير وإعادة النظر في المناهج المتبعة، وفي الأفكار المتبناة، وفي الإنسان المنتدب لتحمل المسؤولية.
أما في المناهج المتبعة فإن أهم منهج أضر بالعقيدة منذ أمد ولعله هو الذي فتح باب الركود منهج استبعاد الكتاب الذي جاء بالعقيدة عن البحوث العقدية، وراح يبحث عن الأدلة ويقدم الإيمان بأسلوب جاف مصروف عن مخاطبة الجوانب المتعددة في النفس البشرية كما فعل القرآن الكريم، فأصبحت العقيدة جزءا من المنطق الأرسطي، أو لا تنفك عنه ولا ينفك عنها، واستحالت إلى تقسيمات وتفريعات تغيب فيها نصاعة الدين ووضوحه ويسره كما جاء به القرآن الكريم.
ونتج عن الإفراط في المنهج الكلامي أن ورث المتكلمون عدم اليقين الذي لا يقدمه العقل أبدا، فكان الجدل الذي استتبع الهجومات والردود، وأجهد أهل العلم أنفسهم وأضاعوا الوقت في الأجوبة والردود، وافتعلوا الخصوم أو خاصم بعضهم بعضا حقيقة، ولعل هذا كان مبررا قديما، على ما فيه من الخطر على المجتمع، لكن العيب والخطر أن يمتد إلى وقتنا وهو واقع، فما زالت المؤلفات على طريقة الردود متتابعة، والهجمات بين أهل العلم مستمرة كأنما هم أهل ملل متناحرة، فقرأنا كتبا من بداية القرن الخامس عشر الهجري ولكنها في روحها كتب القرون الماضية أيام الانحطاط، شكلا ومضمونا بل عناوين أيضا.
وانتقل أثر هذا الاختلاف إلى الواقع فقدم المسلمون عن أنفسهم وعن الدين أسوأ صورة، آخرها لما كان العالمون يستشرفون دخول الألفية الثالثة الميلادية بالعلم وبثورة في الاتصلات وشبكات الإعلام، كان جزء من العالم الإسلامي يرى في هذه الشبكات مجالا حيويا للارتداد إلى الماضي ولكن في جوانبه القاتمة، وفي لحظاته الحرجة، فبدت تلك المعارك والصراعات لم تنته بل لن تنتهي، كل هذا أثر من مناهج تربوية عقيمة بعيدة عن منهج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ، إذ لم يكن يتبع هذه الطريق حتى مع أعدائه فكيف اتبعها أتباعه فيما بينهم وتواصوا بها، ثم أحياها متأخروهم؟؟؟
كما ينبغي البحث الجدي والمفيد في سبيل تقليص الخلاف بين المسلمين، فيكون الأصل في تدريس العقيدة مبادئ الاتفاق والوحدة، وتكون هي الأصول العقدية لأنها هي ما كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو إليه إذا دعا ويبايعه الناس عليه إذا بايعوا؛ ولا يكون همُّ المسلمين تربية الناشئة على الخلاف وكأنه هو الأصل، وقد انقلبت الموازين وتغيرت المفاهيم لما غير المسلمون هذا المنهج، فأصبح الدين الذي جاء للتوحيد سببا للفرقة، وأنشط الناس دعوة إليها أكثرهم حظا في العلم بالخلافيات.
وأما في الأفكار التي ينبغي أن يحملها التوحيد والعقيدة للناس، فهي تلك التي جاء بها القرآن الكريم وبينتها السنة الثابتة، أفكار ترفع من مكانة الإنسان، وتريه منهجا في الحياة متوازنا متكاملا لا يضل معه ولا يشقى، تعلمه كيف يرتقي بنفسه عن الأباطيل والفساد في الأرض، ويزيل الظلم الواقع فيها وينشر فيها الخير والصلاح، ويكون أبعد ما يكون عن الشرور، ويتحصن بعقيدته عن الوقوع في شراك الرذائل مهما كانت درجة الإغراء قوية، لأنه يصبح مبصرا بنور الله تعالى في قلبه، ويصدع بالحق الذي يحمله بين جنبيه، ولا ينساق وراء كل ناعق، ولا يضعف أمام تيارات الإغراء الجارفة المتدفقة عليه من كل جهة وفي كل آن.
وأما عن الإنسان الذي يتحمل هذه المسؤولية وينشرها فينبغي إعداده إعدادا محكما مدروسا، ولعل القطاع الذي تسند إليه هذه المهمة في كل بلد هو قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، ومن في فلك هذه الأجهزة من أئمة ومرشدين ومعلمي المدارس القرآنية، وهي أطراف مهمة بل محورية في التمكين للعقيدة السليمة أن تنتشر بين الناس لأن المنابر في أيديهم، والناس إليهم يجلسون وبهم يقتدون، وعنهم يأخذون، فهم مربو الأجيال والمجتمعات.
والسمة الغالبة على من يتوجهون إلى هذا المجال ـ إلاَّ ما رحم ربي ـ أنهم آخر الأمة حظا من الفقه والمواهب والقدرات الذهنية، ولعل الوهن تسرب إلينا من هذا القبيل من الناس الذين لا يَختارون ولا يُختارون لهذا التخصص مع عظم شأنه وخطره ، وإذا كان هذا شأنهم فلا تستغرب النتائج، والعواقب السابق ذكرها، ولكن وجب العمل على تحميل مثل هذه المسؤولية أقوياء أمناء، لأنهم يؤتمنون على أعز شيء في الوجود هو نشر العقيدة الإسلامية السليمة، ويؤتمنون على حياة المجتمع العقلية والفكرية، وفي هذا جماع كل المصالح الحيوية للأمة الدنيوية منها والأخروية ولا تصلح إحداهما إلاَّ بصلاح الأخرى.
و يدعونا هذا إلى إعادة الاهتمام والاعتبار للمدرسة القرآنية التي لا يمكن أن يستغنى عنها فتوضع لها المناهج المناسبة والأساليب العصرية للتدريس، وتراعى فيها الشروط التربوية، ويرغب الناشئة في ارتيادها، ولنا في تاريخنا القريب أكبر شاهد على مكانة هذه المدارس في حياة الأمة، فإنه لم يحفظ كيانها واستمرارها رغم الأعاصير ولم يحافظ على مقومات الشخصية في نفوس الشباب إلاَّ مثل هذه المدارس في الحواضر والبوادي، وكانت بحق مجاهدة مرابطة أيام الهجوم الشرس على الأمة في مختلف أصقاع العالم، وما زال لها دور بل أدوار تؤديها إلى يومنا لكن ينبغي تحديث الأداء وتوسيع نطاقه ودائرة نشاطه.
هذه نظرات في واقعنا العقدي وهي وإن لفتت النظر إلى جوانب يصعب قبولها لكن يجب القول إنها الواقع الذي لا مفر منه ولا يجدي السكوت عنه، بل يتحتم بحثه بجد وصراحة وصدق وإخلاص، لأنه مستقبل الأمة وفرض على أهل العلم أن يبحثوا فيه، كما لا ينكر أن هناك جهودا تبذل ومساعي حثيثة في أرض الله الواسعة منذ أمد؛ والذي نرجوه هو العمل على تحقيق هذه الآمال وإخراجها من التنظير إلى التطبيق، وفي المقابل ينبغي التفطن إلى أهم أسباب النجاح وهو تضافر الجهود لأن متطلبات العصر لا تسوّغ التجارب المتكررة بغير فائدة، ولا تقبل الأخطاء والأعمال المنعزلة، ولأن النشطين في تغريب العقل وتغييب الوازع العقدي يعملون متظاهرين وإن بدوا مشتتين، لكننا نعمل فرادى وإن زعمنا في العمل أننا متحدون، والله تعالى يذكر عباده بهذا الواقع ويأمرهم بالبقاء على الصراط السوي، «ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون(18) إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين(19) هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون(20)» [س/الجاثية] والحمد لله رب العالمين.
المصدر : فيكوس